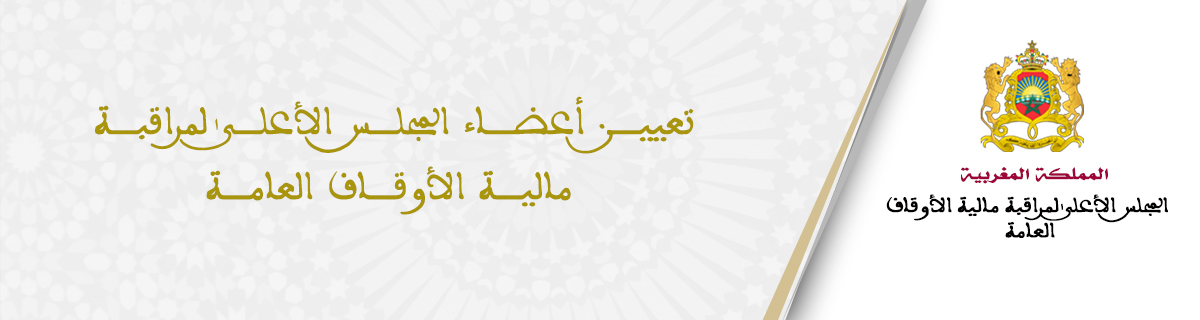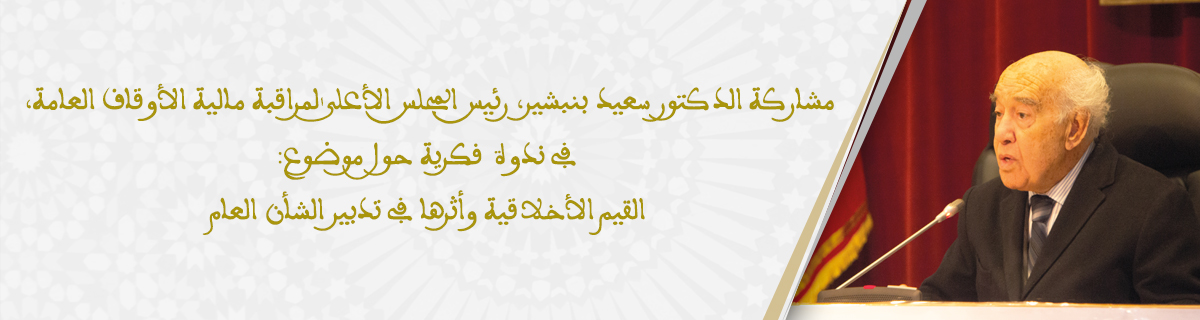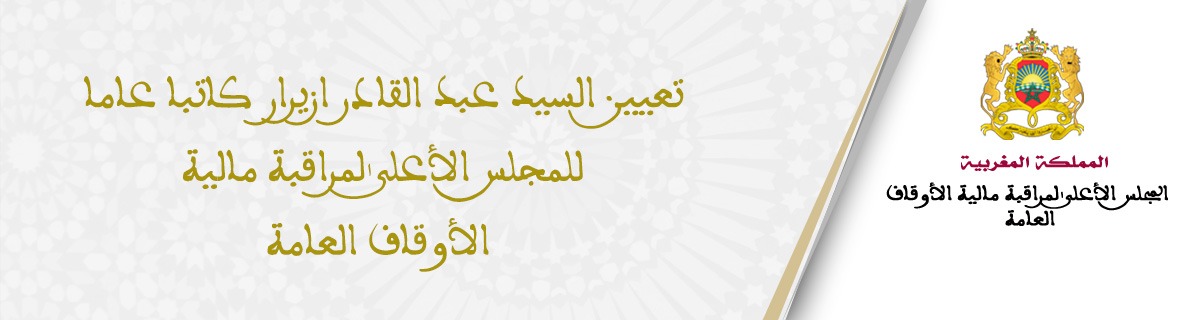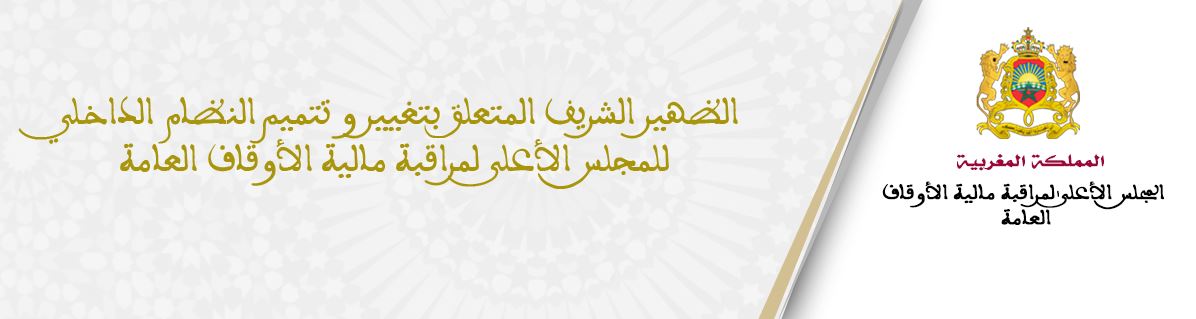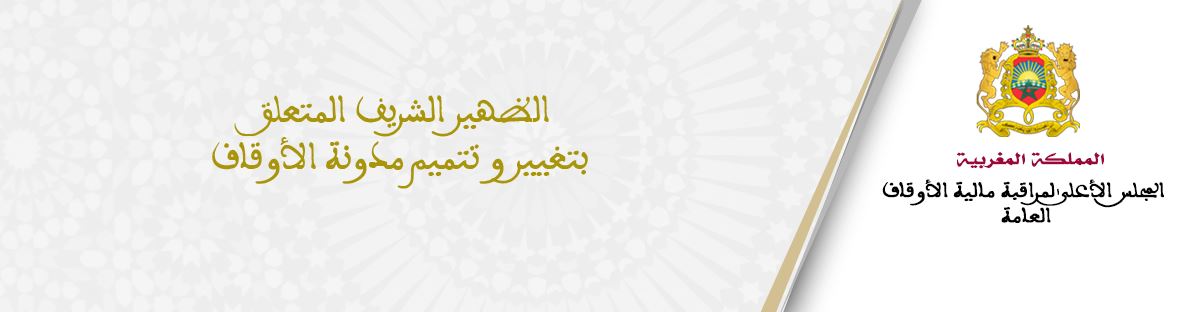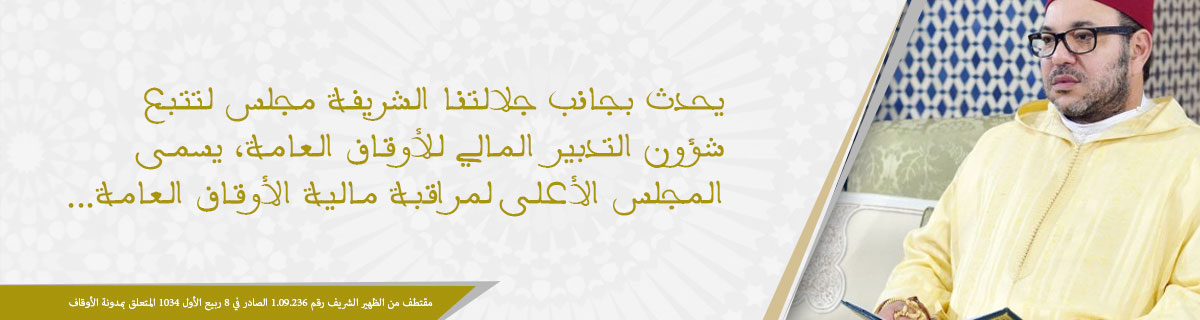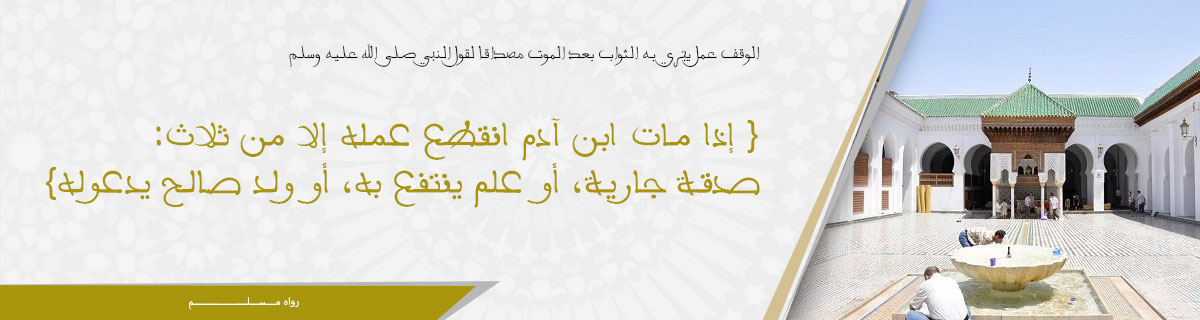- Register
- Login


-
الباب الأول: أحكـام عامــةالمادة 1: تطبيقا لأحكام المادة 162 من الظهير الشريف...الباب الثاني تنظيم المجلس وكيفيات تسييرهالفصل الأول: أجهزة المجلس المادة 4: تطبيقا لأحكام المادتي...
-
الباب الثـالث: الاختصاصات والمساطرالفصل الأول دراسة مشروع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف...الباب الرابع: علاقة المجلس بإدارة الأوقافالمادة 82: يعتبر رئيس المجلس الممثل القانوني للمجلس، والنا...
-
الباب السادس: أحكام ختاميةالمـادة 91: يلتزم المستشارون والخبراء والموظفون المستعان ب...الباب الخامس: وضعية أعضاء المجلس والتزاماتهمالمادة 85: لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الجمع بين العمل...
-
البـــاب الخــــامس: أحكــــام انتق...البـــاب الخــــامسأحكــــام انتقا...البـــاب الــرابــع :تنظيم مالية ا...البـــاب الــرابــعتنظيم مالية الأوقاف ا...
-
البـــــاب الثـــالث : الــوقف الم...البـــــاب الثـــالث الــوقف المعـ...البـــاب الثانـــي: الـــوقـف العــ...البـــاب الثانـــيالـــوقـف العــــام ا...
-
الـبــــاب الأول: إنشـــاء الوقــف ...الـبــــاب الأولإنشـــاء الوقــف و...بــــاب تمهيديبــــاب تمهيديأحــكــــام عامـــــ...
-
الديباجةالظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ر...
روابط مهمــــة
قام نظام الوقف الإسلامي عبر العصور بدور فعال في تطوير المجتمعات الإسلامية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا، وامتدت تأثيراته الايجابية لتشمل أوجه الحياة بجوانبها المتعددة بما في ذلك الدعوة الاسلامية ورعاية رسالة المسجد والمدرسة، واحتضان الطوائف الضعيفة وتشجيع العلم والعلماء وكفالة طلبة العلم والأيتام والغرباء، وإنشاء المكتبات وتشييد المستشفيات ورعاية المرضى، وتمويل الخدمات العامة مثل إنشاء الطرق والآبار، وإنشاء التحصينات وتجييش الجيوش ومدها بالعتاد الحربي للذود عن ديار الاسلام.1
ولعل أهم تنوع اتسمت به الأوقاف الإسلامية في تطبيقها التاريخي كان من حيث أغراضها، فقد تفنن المسلمون في ابتكار أغراض جديدة، قد لا تخطر على البال، مما يدل على توسع الأوقاف الإسلامية توسعا كبيرا استوعب أولا الأهداف القريبة المتبادرة، ثم امتد بعد ذلك إلى أهداف من البر والخير دقيقة تفصيلية، الأمر الذي جعل من الوقف الإسلامي مؤسسة مجتمعية كبيرة، تغني عن تدخل الدولة في تحقيق الكثير من أغراض المصالح العامة للناس في مجتمعاتنا الحضرية والقروية وفي حلهم وترحالهم.2
فكانت أوقاف مياه الشرب والآبار والعيون، وأوقاف الخدمات العامة الأخرى لتشمل تسبيل الطرق والمعابر والجسور، ووجدت الأوقاف على القناديل لتنير شوارع المدن ليلا للعابرين وأوقاف لتقديم الخدمات الفندقية مجانا للأغراب القادمين، ووجدت أيضا أوقاف الحمامات وأماكن النظافة والطهارة، وأوقاف لإغاثة الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، وأوقاف المدارس والجامعات والمكتبات، كما لم تتوقف خيرات الأوقاف على الرعاية المجتمعية للناس بل امتدت إلى رعاية البيئة والحيوان، فوجدت الأوقاف لصيانة الترع والأنهار، وأوقاف لطيور الحرم المكي الشريف، وأنشئت أوقاف لإطعام الطيور والعصافير في مدن عديدة إسلامية، وأوقاف للقطط وأوقاف للحيوانات الأهلية الهرمة والمعتوهة.3
كل هذه الأدوار والوظائف الدينية والاجتماعية للوقف الإسلامي امتدت في سائر الأقطار الإسلامية، وما يقال على الأندلس والشام والعراق ومصر والحجاز يقال على المغرب، فهذا الأخير كبلد مسلم عرف مسلموه بالبر والخير وطلب المثوبة من الله، تأخذ أحدنا الدهشة والفخر وهو يسمع ويقرأ عن أنواع من الأوقاف، تنم عن نبل النفس ويقظة الضمير، حيث وجدت أوقاف متميزة من حيث غرضها والجهة الموقوف عليها.4 نذكر منها: 5
- وقف الزبادي الذي كان في دمشق، حيث مكان توجد فيه صحاف من الخزف الصيني لجليل القدر وقفها أصحابها لأجل أنه إذا كان غلام كسر آنية لسيده وتعرض لغضبه، يذهب إلى هذا المكان ويضع الإناء المكسور ويأتي بإناء صحيح بدلا عنه، بالمقابل كان نظار الأحباس المغاربة يقومون بشراء مواعين الفخار، يعطى من ذلك لمن تكسر له ماعون ممن كان ذاهبا به لغرض من العجزة والصبيان والضعاف مجانا، بعد أن يطلعه على الكسر.
- وقف وجد بالشام لتزويج البنات الفقيرات، مثله وقف في مدينة فاس كان مخصصا لصيانة دار رهن إشارة العرسان لقضاء أسبوع العسل، أيضا هناك وقف ثلاثة ديار كل واحدة بفرشها وأثاثها على من يريد إعمال ولائم الأعراس من المتوسطين والضعاف الذين لا محل لهم، كما أن هناك وقف بمدينة فاس دار الشيوخ محبسة ومعدة لتعريس المكفوفين الذين لا سكن لهم.
- كما عرف بالمغرب صندوق حبسي للقرض بدون فائدة كان موجودا بمدينة فاس.
- وقف بفاس مخصص لأغراض نقل الأزبال وإضاءة البلد وجمع الفئران.
- وقف من وقع عليه زيت مصباح أو تلوث ثوبه بشيء آخر، يذهب إلى هذا الوقف ويأخذ منه ما يشتري به ثوبا آخر.
- وقف وجد لأبي العباس السبتي للعميان والزمنى، يأخذون كل يوم من ريعه ما يعيشون به، ذكورا وإناثا على كثرتهم.
- وقف لرفع الحجارة من الطرقات.
- وقف وجد بمدينة مراكش عبارة عن ملجأ فيه ستة آلاف أعمى ينامون يأكلون ويشربون ويقرأون، ولهم أنظمة وقوانين وهيئة إدارة وصندوق.
- أوقاف البيمارستان لمعالجة المرضى والمصابين بالعاهات، بعدد من المدن المغربية (فاس، مراكش، مكناس ، تطوان..).
- أوقاف مخصصة لتغسيل الموتى وتكفينهم و دفنهم من الفقراء والغرباء.
وقد صاغ العلامة أحمد بن شقرون 6 قصيدة أكد من خلالها على أهمية الأوقاف وعلى ضرورة المحافظة عليها، مبرزا كذلك لأعمال البر والخير الكبرى التي تقدمها مؤسسة الوقف، من بعض ما قال فيها:
|
و في حبس يستحسن السبق للخير |
اصغ تدر ما أسدى أخ الذوق جدا |
|
بمال من الأوقــاف يجبر مـــــن كســـــر |
إذا عطب الـلقـلاق يومـــا فإنــــه |
|
فدار من الأوقــاف تنقــــذ مــن فقـــــــــر |
وإن لم تجد أنثى مكانا لعرسهــا |
|
يعار من الأوقــــاف يوصــل للخــــــــــــدر |
وإن لم تجد عقد الجيد، فإنـــــــه |
| بمــــال من الأوقــاف يصرف للفــــــــــور |
وإن جن مجنون، فإن علاجــــــه |
| يهشمـــها طفـل، فتقطع من أجــــــــــر |
وقد أوقفوا جبر الاواني، ربمـــــــا |
| بلا عوض منه، فيسلــم من خســــــــر |
ولكن بمال الوقف يأخذ غيرهـــــا |
| يردن صلاة في حيــاء و في ستـــــــــر |
وقد أوقفوا دار الوضوء لنســـــــوة |
| يؤذن للمرض بعيــدا من الفجـــــــــــــــر |
وقد أوقفوا وقفا يخص مؤذنـــــــا |
| حجاب ظلام الليل والسقــم والوتــــــــر |
ليكشف عنهم من كثافة غربة |
| معان من الاحسان جلــت عن الحصـــر |
مبرات أوقات الالي قصدوا إلى |
-----------------------------------------------------------------------
1) الوقف الإسلامي، اقتصاد و إدارة و بناء حضارة – عبد العزيز قاسم محارب –دار الجامعة الجديدة 2011- ص18.
2) الوقف الإسلامي- د. منذر قحف- دار الفكر- دمشق 2000- ص 35
3) الوقف الإسلامي- د. منذر قحف- دار الفكر- دمشق 2000- ص39
4) الوقف الإسلامي، مجالاته و أبعاده – د. أحمد الريسوني- منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والتقافة- ايسيسكو- 1422هـ/ 2011م.
5) الوقف في الفكر الإسلامي- ذ. محمد بن عبد العزيز بن عبد الله- الجزء الاول- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1996- ص 131 ومابعدها.
6) الأوقاف الإسلامية ودورها الحضاري- د. عبد ارحمن بن ابراهيم الضحيان- دار المآثر – المدينة المنورة – الطبعة الاولى 2001–ص56.
تحفل ذاكرة الوقف بأسماء نساء رائدات من العالم الإسلامي تركن بصمات مميزة في العمل الوقفي بأحباس وأوقاف طبعت مجالات عدة في حياة الإنسان، سواء ما يتصل منها بالشعائر الدينية، أو بطلب العلم والتعليم، أو بالخدمات الاجتماعية أو ما يتعلق منها بالأنشطة البيئية والزراعية.
وإن كان المقام يضيق بذكر الأسماء الكثيرة في هذا المجال، حيث يظهر أن المرأة شاركت بنصيب وافر ومقدر في تطور الوقف، فإننا سنكتفي بذكر نماذج لتجارب نسائية رائدة من أزمنة مختلفة أسهمن في إنشاء الوقف وإدارته وتنميته.
.1 السيدة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (دار المدينة المنورة(
لقد كان لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في البذل والعطاء والوقف، حيث اشترت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما منزلا ووقفته، وكتبت في شرائه: أني اشتريت منزلا وجعلته لما اشتريت له، فمنه مسكنا لفلان ولعقبه ما بعده إنسان، ومسكن لفلان (وليس فيه ولعقبه) ثم يرد ذلك إلى آل أبي بكر1.
.2 السيدة فاطمة الفهرية (جامع القرويين (
يعد هذا المسجد التاريخي العظيم الذي أنشأته السيدة فاطمة بنت الشيخ الفقيه أبي عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه الفهري القيرواني بمدينة فاس، المعروفة باسم فاطمة أم البنين. وكانت رحمها الله، قد ورثت عن والدها ثروة مباركة لم تطب نفسها إلا بأن تهبها للَّه تعالى فتبني بها مسجداً جامعاً، واختارت له الأرض المناسبة بنفسها، ودفعت ثمنها (ستين أوقية من الذهب) مع تكاليف البناء2. وقد تم الشروع في بناء هذا الجامع في شهر رمضان الأبرك من عام 245 هـ، ونذرت السيدة فاطمة الفهرية أن تصوم للَّه طيلة مدة بنائه.
.3 السيدة مريم الفهرية (جامع الأندلسيين(
يعتبر جامع الأندلسيين الشقيق الأصغر لجامع القرويين بفاس، فقد بنته السيدة مريم الفهرية شقيقة السيدة فاطمة الفهرية بانية جامع القرويين. والمسجدان هما أيضاَ شقيقان من جهة بنائهما، في وقت واحد في مدينة واحدة.
.4 السيدة مسعودة الوزكتية (جامع باب دكالة(
شيدت والدة الخليفة السعدي أحمد المنصور السيدة مسعودة الوزكتية جامع باب دكالة بمراكش، وجهزته بخزانة للكتب، كما خصصت له أحباسا للكراسي العلمية و ذلك سنة 995 هـ3.
وقد تحدث عنه المقري4 فقال: "وقد ابتنت أم مولانا نصره الله جامعا عظيما بباب دكالة وأكثرت عليه من الأوقاف والجرايات وخزائن الكتب وكراسي أنواع العلوم.5"
.5السيدة فوز جارية (رباط الحجازية(
أنشأت السيدة فوز جارية علي بن أحمد الجرجرائي الوزير رباط 6 الحجازية بجوار مسجدها بالقاهرة 415هـ، وأوقفته على أم الخير الحجازي، وكانت الحجازية واعظة زمانها وقد تصدرت حلقات الدرس والوعظ في جامع عمرو بن العاص، كما عنيت بتثقيف المقيمات بهذا الرباط.7
.6السيدة خاصكي سلطان (تكية خاصكي سلطان(
أنشأت السيدة روكسلانة خاصكي سلطان زوجة السلطان العثماني سليمان القانوني سنة 960 هجري/1552 ميلادي، في مدينة القدس بجوار المسجد الأقصى المبارك تكية8 خاصكي سلطان، وكانت من أكبر المؤسسات الخيرية في فلسطين طيلة العهد العثماني، واستمرت في تقديمها للخدمات الجليلة للفقراء والمرابطين والمسافرين لسنين عديدة، كما أوقفت على التكية قرى ومشاريع تدر أرباحا لتسد احتياجات التكية ومصاريفها والعاملين عليها، وقد بلغت المشاريع والقرى الموقوفة على التكية زهاء 29 قرية ومزرعة ومشروعا حسب ما ورد في وقفيتها9.
.7 السيدة زبيدة بنت جعفر بن المنصور (بئر زبيدة) المشروع المائي بمكة
شيدت السيدة زبيدة زوجة الخليفة هارون الرشيد مشروعا مائيا كبيرا من الآبار والبرك والصهاريج بمكة المكرمة، أشهرها البئر المعروف بـ "زبيدة"، وحفرت العين المعروفة بـ "عين المشاش" برأس الحجاز، وأجرتها من مسافة اثني عشر ميلا إلى مكة و عرفة في قناة محكمة.
ولما شاهدت ما يعانيه أهل مكة من التعب والمشقة للحصول على ماء الشرب، بحيث لم يكن لهم مناهل وينابيع، بل كانوا يعتمدون على ماء المطر، وعلى بعض الآبار التي تفيض أحيانا وتجف أحيانا أخرى، وأمرت خازن أموالها بدعوة المهندسين والعمال من أنحاء البلاد وقالت لهم كلمتها المشهورة "إعمل ولو كلفتك ضربة الفأس دينارا"10.
.8 السيدة تذكار باي خاتون (رباط البغدادية(
أنشأت السيدة تذكار باي خاتون ابنة الملك الظاهر بيبرس "رباط البندقداري" بالقاهرة سنة 684 هـ، وأنزلت به الشيخة الصالحة زينب بنت أبي البركات المعروفة ببنت البغدادية ومعها عدد من السيدات الخيرات، و أمرت بالصرف عليهن11.
.9 السيدة عزيزة عثمانة (مارستان تونس(
يذكر التاريخ السيدة عزيزة عثمانة زوج حمودة باشا المرادي ببناء مارستان12 تونس سنة 1080 هـ، أوقفت عليه من الرباع والعقار ما هو كثير13، وتحبيسها أيضا على فك الأسرى وتجهيز الأبكار، وختان الصبية الفقراء، بما في ذلك كسوتهم وأجرة الخاتن.
.10 السيدة طغاي أم أنوك (خانقاه أم أنوك(
أنشأت السيدة طغاي أم أنوك زوجة السلطان المماليكي الناصر محمد بن قلاوون سنة 745 هـ خانقاه14 بالقاهرة، ورصدت عليها الأوقاف الكثيرة، وقررت لكل جارية من جواريها مرتبا يسهرن على خدمة العباد والفقراء وعابري السبيل15.
.11 السيدة فاطمة عثمانة (سجن القصبة(
حبست السيدة فاطمة عثمانة إحدى أميرات سلالة الحسينون بتونس، أموالا كثيرة تصرف في إطعام وتغذية ورعاية نزلاء سجن القصبة بتونس16.
.12 السيدة أم أبي نصر (المدرسة البشيرية(
وقفت زوجة الخليفة المستعصم أم ولده أبى نصر المعروفة بباب بشير، "المدرسة البشيرية" في بغداد سنة 356 هـ، وجعلتها للمذاهب الأربعة17 فأوقفت عليها الكتب والأموال، وكانت كتبها تعار خارج أسوار الجامعة لقاء رهن للحفاظ عليها وضمان إعادتها، مثلما جرى عليه العمل في المكتبات الخاصة بالمدارس الأخرى.
.13 السيدة أروى بنت أحمد الصليحي (مراعي الحيوانات(
تميزت السيدة الملكة أروى بنت أحمد الصليحي (الدولة الصليحية في اليمن 439 هـ 1047 م) التي كانت على قدر كبير من رجاحة العقل وبعد النظر وقوة الإدراك، حتى أنها كانت تلقب بـ"بلقيس الصغرى"، باهتمامها بالثروة الحيوانية حيث أوقفت عليها الأراضي الواسعة ومنها مرعى حلبة السيدة في ضاحية مدينة "إب" ومساحتها مئات الفدانات، كما أوقفت أيضا أراض أخرى ليصرف ريعها لشراء فحول الضراب وتلقيحها18.
------------------------------------------------------------
-1الخصاف، أبو بكر أحمد بن عمر، أبو بكر أحمد بن عمر الخصاف- كتاب أحكام الأوقاف مطبعة ديوان الأوقاف المصرية 1904 - ص 13
-2أحمد الريسوني - الوقف الإسلامي مجالاته وأبعاده – طبعة 2001 ص 54
-3رقية بلمقدم، أوقاف مكناس في عهد مولاي إسماعيل، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 1413هـ / 1993م، ص 82.
-4أحمد المقري: روضة الآس العاطرة الأنفس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش وفاس – المطبعة الملكية, ط 2 1983 ص63
-5من نص تحبيس ما أوقفته مسعودة الوزكيتية من أعيان على جامع باب دكالة بمراكش
-6الرُّبُط (جمع رباط) كانت تجمع بين التعبّد والتعليم والجهاد، و تقوم بالإيواء والإطعام للوافدين عليها والعابرين بها.(رقية بلمقدم، م س ص 42(
-7محمد بن أحمد بن صالح الصالح – الوقف في الشريعة الإسلامية و أثره في تنمية المجتمع – 2001 ص 177
-8التكية: أطلق العثمانيون على الخوانق والزوايا التي كانت قبلهم أو تلك التي أسموها اسم التكية و هي المكان الذي يقيم فيه الناس حيث يقضون أوقاتهم في العبادة و يأكلون مجاناً ، كما أنها قامت خلال العصر العثماني بدور آخر وهو تطبيب المرضى وعلاجهم وهو الدور الذي كانت تقوم به البيمارستانات في العصر الأيوبي والمملوكي، إلا أنه مع بداية العصر العثماني أهمل أمر البيمارستانات وأضيفت مهمتها إلى التكايا.
-9منى القواسمي - القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009
-10عفاف عبد الغفور حميد – مساهمات المرأة في الوقف الإسلامي العلمي: نماذج عبر التاريخ- 2011 ص 8
-11محمد بن أحمد بن صالح الصالح – م.س. ص 178
-12مارستان أو بيمارستان هي كلمة معناها مستشفى أو محل المرضى و هي كلمة داخلية فارسية و يستعمل المؤرخون المغاربة لفظة مارستان باسم "بيمارستان مراكش" الذي أسسه يعقوب الموحدي و تعتبر أيضا المارستانات بمثابة معاهد لتدريس الطب.
) يوسف لوشيوني – المؤسسات الحبسية في المغرب من النشأة إلى سنة 1956 – ترجمة نجيبة أغرابي ص 174.(
-13محمد بن عبد العزيز بنعبد اللًَّه - الوقف في الفكر الإسلامي، المغرب 1996 ص 150.
-14الخوانق (جمع خانقاه) هي مكان اختلاء وإقامة وعبادة المتصوفة والزهاد المنقطعين عن الدنيا للعبادة – بمعناها الشعائري الخاص – وكانت توقف عليها الأوقاف التي يفي ريعها بما تحتاج من نفقات. و كان للخانقاه مرافقها المعاشية، من مخبر ومطبخ ومشرب، وغيرها و بها أيضا عـدد من الغـرف مخصصة لإقـامة الفقـراء وعابـري السبيـل. (قاموس المؤسسات المالية الإسلامية)
-15محمد بن أحمد بن صالح الصالح – م.س. ص 178
-16رندى ديغليم – الوقف في العالم الإسلامي: أداة سلطة اجتماعية و سياسية –دمشق 1995، ص 42.
-17إسهام المرأة في وقف الكتب في منطقة نجد إعداد د . دلال بنت مخلد الحربي - ندوة المكتبات الوقفية في السعودية ص 718
-18عفاف عبد الغفور حميد – م س. ص 13
تشكل الأوقاف الإسلامية بالمملكة المغربية تراثا خالصا للمسلمين المغاربة، تركه السلف ضمانة مادية لاستقرار الإسلام واستمرار تعاليمه بينهم ايمانا منهم بأهميته التي لا تنحصر في البر والإحسان بل تشمل كافة مجالات الحياة دون اقتصار على مجال معين.
فالمغاربة لما عرفوا قدسية الوقف، باعتباره من أطيب المكاسب التي تشكل نظاما اجتماعيا أصيلا يستمد أسسه من الشريعة الإسلامية ويهدف الى تعزيز الروابط بين الأفراد ظلوا في مختلف عهودهم ومستوياتهم الاجتماعية يحرصون على تحبيس شيء من ممتلكاتهم في سبيل الله وذلك لصرف ريعها ومدخولها في وجوه الخير المختلفة وإقامة شعائر الدين وتحقيق المنافع العامة للمسلمين.
وعليه فالمغرب كغيره من البلدان الإسلامية عرف الوقف العام بوصول الفاتحين المسلمين1، فكانت المساجد هي طليعة المؤسسات الوقفية التي ظهرت واستقرت2 بالمغرب حيث يرجع تاريخها الى أيام عقبة بن نافع الفهري3، لتحتل بذلك مكانة عظيمة في حياة المجتمع حتى أصبح من النادر أن يخلو حي أو زقاق من مسجد أو عدة مساجد، خاصة وأن المبادرات الفردية أو الجماعية للمحسنين ساهمت بحظ وافر في التكثير من عددها سواء بما رصدوه لها من هبات مالية أو ما وقفوه عليها من رباع وعقارات4.
لكن مع اطراد ممارسة الوقف في الواقع الاجتماعي للمغاربة عبر المراحل التاريخية المتلاحقة سرعان ما ظهرت ألوان شتى من الوقوف على اختلاف أنواعها الدينية والتعليمية والاجتماعية والصحية ، وأصبح لها دور بارز في توفير الكثير من الخدمات للمجتمع بطريقة تلقائية وتطوعية من جميع طبقات المجتمع المغربي وتبعا لحاجاته.
فالسلاطين الدين تعاقبوا على الحكم بالمغرب لما أدركوا قدسية الأوقاف وحرمتها الدينية ،وتيقنوا أنها خير ضمانة تابثة تحفظ مصير الملة الإسلامية مما تهددها من أخطار اجتهدوا في حمايتها5 من كل اعتداء أو تصرف مخالف للأهداف التي حبست من أجلها.
ومما يدل على العناية بالوقف عبر التاريخ المغربي ما نعرفه من توالي بناء المنشآت الوقفية ، ففي عهد الإدارسة تم بناء جامع القرويين بفاس الدي لا يخفى على أحد ما لهدا المسجد من الريادة والخصوصية والدلالة، اضافة الى جامع الأندلسيين بفاس كدلك ومسجد باب دكالة بمراكش.
أما عهد الدولة المرابطية فقد شهد بناء مجموعة من المدارس التي كانت ملاذا لطلاب العلم من جميع الجهات على نفقة الأحباس.
وفي صدد الإهتمام بالعلم وطلابه نجد أن أول خزانة وقفت بالمغرب كانت في عهد الموحدين6، اضافة الى المساجد7 والمدارس التي كان لها الأثر البارز في تنمية الثقافة ونشرها في هدا العهد.
أما المرينيون فقد اهتموا بتنظيم الوقف وتعيين مشرفين مباشرين له معتمدين في ذلك على مجموعة من التقنينات المستمدة من فتاوى الفقهاء حيث أحدثوا نظارات للوقف بمختلف الحواضر وجعلوا لكل حبس ناظرا 8، كما ضبطوا رباع الوقف عن طريق نظام الحوالات الحبسية، كما سعوا الى إنشاء الكراسي العلمية لتدريس العلوم الدينية والشرعية ووقفوا عليها عقارات ومنقولات، فتوافرت أحباسها وتزايدت. كما اجتهدوا في جانب المكتبات فشيدوا الجديدة منها ووسعوا القديمة في مدن مغربية عدة كتازة ومكناس وسلا ومراكش وسبتة 9، كما اعتنوا ببناء المساجد والمستشفيات وعهدوا بإدارتها لأشهر الأطباء للاعتناء بالمرضى.
ولعل ما يمكن ملاحظته في هذا العهد هو اتحاد المدارس والخزانات العلمية مما هيأ الوسائل الكافية لنشر العلوم والمعارف على أوسع نطاق في عهد الدولة الوطاسية التي اهتمت كذلك بالكراسي العلمية لأنها كانت بمثابة ولاية حكومية لا تقل عن منصب القضاء والفتيا والوزارة، كما تم تسخير مداخيل الأحباس الكثيرة في هذه الحقبة للإنفاق على المرضى والمنقطعين. الا ان سوء تدبير الأموال الموقوفة خلال هده الفترة جعلها تتراجع وكان هذا من المشاكل التي وقع على كاهل السعديين أمر علاجها، ذلك أن التنظيم السعدي للأوقاف جاء امتدادا لما عرف في العصر المريني، حيث تبلورت مساهمتهم في تشييد المساجد أو ترميمها، واحياء بعض المدارس وتأسيس أخرى10، وإنشاء المكتبات وتزويد القديمة منها بالمؤلفات 11، إضافة الى انشاء عدد من السقايات بجوار الجوامع، الا أن الملاحظ خلال هذه الحقبة هو غياب أنواع من الوقف خاصة الأوقاف الإجتماعية.
وتبقى أهم مرحلة في تاريخ نظام الوقف بالمغرب عامة هي مرحلة الدولة العلوية، حيث ظهرت معطيات جديدة جعلت الدولة تحتضن الوقف لأن سلاطين المغرب كانوا محافظين تمام المحافظة على مبدأ أن الأحباس لاتباع ولا ترهن ولا يضيع منها قليل ولا كثير، ايمانا منهم بأن الملة إذا لم تكن لها أوقاف تابثة، مصونة، تنفق عليها وتصرف على القائمين بحفظها ونشر تعاليمها فإنها تصبح معرضة لكثير من الأخطار 12، مما كان له الأثر الإيجابي في نفوس المغاربة الذين أقبلوا على التحبيس.
ومن المواقف التي سجلها التاريخ لملوك الدولة العلوية ايلائهم العناية الفائقة لشؤون الوقف، حيث أسبغوه كريم رعايتهم، حيث ساندوه وحافظوا على مؤسساته التعليمية من مساجد، ومدارس وزوايا، وكتاتيب قرآنية، وأسسوا خزانات علمية شحنوها بالألاف من أنفس الكتب العلمية تسهيلا وتيسيرا على طلبة العلوم، كما قاموا بإحصاء جميع الممتلكات الوقفية وتسجيلها في دفاتر رسمية، وذلك مخافة الضياع والنسيان نتيجة كثرة الأوقاف بالمملكة.
لكن ابتلاء المملكة بنظام الحماية الفرنسية جعل هذه الأخيرة لم تدخر جهدا لاستنزاف الممتلكات الحبسية، لكن الحكومة الشريفة انداك نجحت في جعل مؤسسة الوقف خارج نطاق معاهدة الحماية.
وخلال مرحلة ما بعد الإستقلال بقي تنظيم الوقف يرتكز على مجموعة من الظهائر الشريفة التي يصطلح على تسميتها بالظوابط الحبسية، رغم تطور مؤسسة النظارة على الوقف التي انتقلت من "بنيقة الأحباس" الى وزارة للأوقاف مهيكلة طبق معايير الإدارة الحديثة .
ومع تنامي المجتمع المغربي، ظهرت الحاجة الى إعطاء الموال الموقوفة وحمايتها حماية قانونية أكبر لتنميتها واسثتمارها، وذلك لتحقيق الهداف المنشودة منها وهو ما تجسد فعلا بصدور مدونة للأوقاف، جمعت بين دفتيها شتات النصوص القانونية المتعلقة بالوقف، والقواعد الفقهية الخاصة به المتناثرة في كتب الفقه الإسلامي وذلك في انسجام تام، يراعي خصوصية الوقف، ويساهم لا محالة في توفير الحماية الفعالة له.
------------------------------------------------
-1أحمد الريسوني: الوقف الإسلامي مجالاته وأبعاده ، منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ايسسكو ص:29.
-2أحمد الريسوني: المرجع السابق ص 29.
-3رقية بلمقدم: أوقاف مكناس في عهد مولاي اسماعيل .الجزء الأول .منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية .ص42.
-4رقية بلمقدم: المرجع السابق ص43.
-5من مظاهر حماية الأوقاف على امتداد التاريخ المغربي إصدار مجموعة من الظهائر تحث القائمين على الأملاك الحبسية على حسن تدبير هده الممتلكات ومراقبتها وهو ما قام به المولى اسماعيل من احصاء للأوقاف وتسجيلها في دفاتر خصوصية رسمية تشكل وثائق تاريخية ومن دلك ما يسمى بالحوالات الحبسية .
-6أنظر لمزيد من المعلومات: السعيد بوركبة :دور الوقف في الحياة لثقافية بالمغرب في عهد الدولة العلوية ،الجزء الأول ص:66.
-7من هده الجوامع الجامع الأعظم بسلا وجامع المنصور بمراكش انظر السعيد بوركبة المرجع السابق ص71.
-8محمد المنوني : ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين : منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط ص:64.
-9رقية بلمقدم .المرجع السابق ص:73.
-10من هذه المدارس مدرسة أقا بأقصى الجنوب،ومدرسة الحسن التاملي بتتيوت ، والمدرسة البرحيلية بالمنابهة قرب تارودانت.
-11رقية بالمقدم :المرجع السابق ص: 81.
12- محمد المكي الناصري : الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية .منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السنة:1412/1992 ص20.
لقد عرفت العديد من الشعوب القديمة بعض أشكال الوقف، تبعا لحاجيات المجتمع، بحيث وجدت دور وأمكنة للعبادة، وخصصت أراض و مبان أريد بها تقديم منافع للناس (مندر قحف، الوقف الإسلامي، 200، ص: 17)، لذا، فالوقف معروف عند أمم سابقة قبل ظهور الإسلام كما هو الحال عند البابليين، والرومان وغيرهم، وإن كان لم يسم بهذا الاسم (تاريخ الوقف عند المسلمين، أحمد بن صالح العبد السلام، ص : 16).
لذلك، ففكرة الوقف التي يراد في فحواها حبس العين عن التملك، ورصد منافعها لجهة معينة، تعد في ذاتها فكرة متجدرة في القدم، وقبل ظهور الإسلام (محمد عبيد الكبيسي، أحكام الوقف في الشرعة الإسلامية، 1977، ص : 22) ومن الأوقاف الذي اشتهرت به العرب قبل الإسلام، الوقف على الكعبة المشرفة لعمارتها وكسوتها، فكان أول من كساها ووقف عليها أسعد أبو كريب ملك حمير (مقدمة إبن خلدون،3-842)، لكن إذا كان لايمكن إنكار هذه الحقائق التاريخية، إلا أن البون يبنها وبين غاية الوقف في الإسلام تتكشف من خلال أن أحباس في الجاهلية كان يتوخى من خلالها التفاخر، خلافا لأوقاف المسلمين، فالأصل فيها هو التقرب لله تعالى ونيل مرضاته (محمد عبيد الكبيسي، أحكام الوقف في الشرعة الإسلامية، م، س، ص: 22).
وعلى كل، فإن كنا هنا لسنا بصدد رصد المسار التاريخي لمؤسسة الوقف بإعمال "منهج التأريخ"، ولكن نروم فقط إثبات الأهمية الدينية والاجتماعية لهذه المؤسسة حسب تطور المجتمعات، ونظرتها للغاية والوظيفة التي أريد لها.
ولا جرم أن بحث تاريخ الوقف عند المسلمين تحديدا من الأمور التي خاض فيها العديد من الباحثين، اتسمت بالغزارة، غزارة الوقف في ذاته، حيث أكد العديد منهم أن الوقف عرف في حياة الرسول، الذي كان أجود الناس، وأخيرهم (أنظر الطبقات، لإبن سعد، 1/ 188)، ونحى منحاه الصحابة الأخيار، فتجسد ذلك في "وقف عمر بن الخطاب" و "وقف عثمان بن عفان"، و"وقف طلحة" و"خالد بن الوليد" وغيرهم كثير ممن ساروا على السمط والنهج القويم ابتغاء مرضاة الله تعالى.
هذا، وقد ذكر الخصاف على أن محمد بن عبد الرحمن عن سعد بن زراة قال: "ما أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر من المهاجرين والأنصار، إلا وقد وقف من ماله حبسا، لا يشترى، ولا يورث ولا يوهب، حتى يرث الله الأرض ومن عليها " (أحكام الأوقاف للخصاف الطبعة الأولى ، ص : 15 .(
لكن مع اتساع الديار الإسلامية، وتطور المجتمع الإسلامي، تنامت بالضرورة حاجات الناس، فكان من نتائجه تزايد حجم الأوقاف، لذلك فقد عد عصر الخلفاء الراشدون أفضل العصور بعض عصر النبوة في هذا المجال، واستمر هذا الحال في العهد الأموي، فتزايدت الأوقاف ومآلات إنفاقها، الأمر الذي أدى إلى إنشاء ديوان مستقل له عن بقية الدواوين، تحت إشراف قاض، يتولى لأول مرة تسجيل الأحباس في سجل خاص حماية لمصالح المستحقين لها.
ومند ذلك الحين أصبحت الأوقاف تابعة للقضاة يحفظون أصولها، ويرعونها، ويشرفون على وجوه صرفها (محمد عبيد الكبيسي، أحكام الوقف في الشرعة الإسلامية، م، س، ص: 38،39 )، ويعتبر هذا الديوان أول تنظيم للأوقاف من نوعه، ليس فقط في مصر، بل في كافة الدول الإسلامية (علي، محمد محمد أمين، تاريخ الأوقاف في مصر في عصر سلاطين المماليك (1250 -1517م)، جامعة القاهرة، كلية الآداب، 1972،ج 1 ص: 49).
ومن الأثر الحضاري للوقف في العصر الأموي يتمثل في قبة الصخرة، ذلك أن الخليفة عبد الملك بن مروان سعى إلى إقامة بناء يعتز به المسلمون قاطبة في سائر الأصقاع الإسلامية (توفيق أحمد عبد الجواد، تاريخ العمارة والفنون الإسلامية، الطبعة الثانية 1970، ص: 293).
وإلى جانب الخلفاء الأمويين، لم يتخلف أيضا العباسيون على إيلاء اهتمام خاص بالأوقاف، وتنميتها وتنويعها، إذ لم يقتصر على الفقراء والمساكين، وطلبة العلم فحسب، بل تعداه إلى إنشاء المكتبات والمصحات، ودور لسكن المعوزين (تاريخ الوقف عند المسلمين، أحمد بن صالح العبد السلام، ص:3)، وفي عهدهم أيضا كانت تتم إدارته بواسطة رئيس سمي " صدر الوقوف"، أنيط به مهمة الإشراف عليه، مع تمتيعه بصلاحية تعيين أعوان إلى جانبه لمساعدته في أمور التدبير والتسيير. (محمد عبيد الكبيسي، أحكام الوقف في الشرعة الإسلامية، م، س: 39 ).
وهكذا بات جليا أن كلا من الأمويين والعباسيين، وبحكم اتساع الأوقاف، فإن ذلك أدى إلى إنشاء أجهزة تتولى إدارتها والإشراف عليها، فكان القضاة توكل إليه هذه المهمة، فكانوا يشرفون عليها بأنفسهم ويحاسبون المتولين عليها.
وفي هذا السياق العام، سار سلاطين الدولة العثمانية، فإلى جانب ازدهار مؤسسة الوقف في عصرهم، فقد حرصوا على إحداث أجهزة إدارية لتدبيرها والإشراف عليها، كما أقدموا على إصدار قوانين وأنظمة متعلقة بأحكام الوقف تنظم شؤونه وأمور تدبيره " فمن الأنظمة التي صدرت في العهد العثماني: نظام إدارة الأوقاف الذي نظم كيفية مسك القيود من قبل مديري الأوقاف، وكيفية محاسبة مدير الأوقاف الجديد لمن سبقه، وتعمير وإنشاء المباني على العقارات الخيرية، وكيف يتم تحصيل حاصلات الوقف وغير ذلك من الأحكام المنظمة لأعماله ". (عبد الله بن أحمد الزيد، أهمية الوقف وحكمة مشروعيته، مجلة البحوث الإسلامية، ص: 201 ، الجزء رقم : 6 ، العدد 36، 1413 ه).
وعلى كل، فإن هذه الوقفات التاريخية من حقب زمنية معينة تبقى مجرد كشف يسير جدا لمكانة الأوقاف في المجتمعات الإسلامية، يراد من خلالها إماطة اللتام عن جوهر مكنون، ظل وما يزال يغري الدارسين لسبر أغواره تبعا لتخصصاتهم، فمؤسسة الوقف إذن ليست وقفا في الدراسة على الفقيه الشرعي، بل أيضا على المؤرخ، والقانوني، والاقتصادي وغيرهم.
مجموعات فرعية

اليوم 29
الأمس 106
هذا الأسبوع 702
هذا الشهر 2609
الكل 95471

![]() 75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب
75 زنقة سبو٬ أكدال٬ الرباط - المغرب
![]() 50 26 27 37 5 212+
50 26 27 37 5 212+
![]() 55 26 27 37 5 212+
55 26 27 37 5 212+
![]() عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

يعدّ إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة ثاني تجربة يعرفها المغرب في مجال إسناد مهام مراقبة التدبير المالي للأوقاف العامة إلى مؤسسة مستقلة عن الوزارة الوصية، حيث كانت التجربة الأولى من خلال "المجلس الأعلى للأحباس" الذي أحدث بموجب الظهير الشريف الصادر بتاريخ 16 جمادى الثانية 1332 الموافق لتاريخ 12 ماي 1914.